فيلم Poor Things: هل تخلّص العالم المعاصر من المسوخ القديمة؟


في الرابع والعشرين من كانون الأول/ديسمبر الماضي؛ عُرض في دور السينما الأميركية فيلم poor things (أشياء مسكينة)، من بطولة ايما ستون، وويليام دافو، ومارك رافالو، وإخراج المخرج اليوناني يورغس لانثيموس. رُشح الفيلم لـ328 جائزة، وفاز في 63 منها، مثل “البافتا” و”اختيارات النقاد”، و”مؤسسة شيكاغو”، و”جولدن غلوب” وغيرها.
وعلى رغم العدد الكبير من الجوائز، واعتبار كثير من النقاد والمشاهدين الفيلم أفضل فيلم لعام 2023، إلا أن التعليقات السلبية لم تكن قليلة أيضا، والسبب هو قصة الفيلم، والقضايا التي يناقشها في المقام الأول، مثل النسوية والحرية الجنسية والعلم والدين، وغيرها من القضايا الكبيرة جدا، والتي من الصعب أن يتسع لها فيلم مدّته 141 دقيقة. ففي عالم سوريالي، عناصره شديدة الغرابة، عالج السيناريست توني ماكنمارا، رواية من التسعينات، للكاتب الأسكتلندي ألسدير غراي، تحمل عنوان الفيلم نفسه. تمزج الرواية الأصلية عناصر خيالية وواقعية، وتجري أحداثها في العصر الفيكتوري في لندن، خلال القرن التاسع عشر، في أجواء سطوة علوم التشريح، واستحداث الفلسفة العلمية، التي أثّرت في مختلف العلوم، سواء الطبيعية أو الإنسانية، وسيادة الروح التجريبية، والرغبة في استكشاف جميع جوانب الثقافة والمجتمع.
يُشرّح “دكتور غودوين”، في الرواية والفيلم، الجسد، ويستخرج مكنوناته، ليصل إلى “حقائق” حول الروح والذات الإنسانية. فماذا أراد الكاتب ألسدير جراي أن يخبرنا في نصه الغريب؟ ولماذا عُدّت روايته انعطافا في مسيرته، وجعلته يوصف بـ”الكاتب بعد الحداثي”؟ وما الذي توصّل إليه كل من الفيلم والرواية حول مفهوم الذات الإنسانية؟ ما الذي يعنيه أولئك الأدباء والفلاسفة عندما يقولون: “ذواتنا اختراع حديث”؟
نشرت الأديبة الإنجليزية ماري شيللي روايتها الشهيرة “فرانكنشتاين” عام 1818، وفيها يقوم العالم فيكتور فرانكنشتاين بخلق كائن من جثت ميتة، أعادها للحياة، بغاية واحدة، هي إرضاء شغفه بالعلم. لكنه لا يلبث أن ينبذ المسخ الذي اخترعه، لأنه كان “مشوّها”، ولا يقترب من الكمال، الذي كان يتخيله.
هذا النبذ ترك بصمته في وعي المسخ/المخلوق، الذي أراد أن يتقرّب من البشر، ويحصل على اعترافهم، لكنه يُقابل كل مرة بالنبذ والقسوة، أولا من خالقه فرانكنشتاين، ثم من الناس الذين اقترب منهم، وتعلّم عاداتهم ولغتهم. لتتحول القصة إلى لعبة مطاردة بين الوحش وخالقه، يقتل فيها المسخ أفراد عائلة الدكتور فرانكنشتاين، واحدا بعد الأخر، فيقرر الأخير مطاردة المسخ، والاقتصاص منه، وصولا لنهاية العالم حرفيا (القطب الشمالي).
اعتُبرت رمزية الدكتور فرانكنشتاين والمسخ في الرواية نظرة تشاؤمية للحداثة، وهي “الوحش” الذي صنعه البشر على عجل، خلال القرنين الثامن عشر والتاسع عشر، ولكنه لم يكن كاملا أو مثاليا أبدا، بل ارتدّ على صانعه وانتقم منه. وهذا كان مجازا واضح الدلالة، في الزمن الذي صدرت فيه الرواية، فالظروف المعيشية، المُعاصرة للثورة الصناعية في إنجلترا، فرضت حالة من البؤس المُقيم على كل عمال المدن، الوافدين من الريف، والذين اضطروا، بعد اقتلاعهم من أراضيهم، العمل في ظروف غير آدمية، فقط لصالح زيادة الإنتاج، وتحقيق انجاز تكنولوجي وعلمي وسياسي. أولئك هم “المسخ” الذي خاف منه آنذاك العالم البرجوازي، الذي تنتمي إليه شيلي.
بعد أكثر من قرن ونصف على صدور “فرانكنشتاين”، نشر الروائي الأسكتلندي ألسدير جراي روايته “أشياء مسكينة”، ويمكن اعتبارها نُسخة مُعدلة من رواية ماري شيلي، ففي أحد الأيام يكتشف الدكتور غودوين جثة لسيدة تدعى فيكتوريا، وأثناء فحصها يكتشف أنها قررت الانتحار، وفي أحشائها مولود، لكنها وفت الفحص، لم تكن قد فارقت الحياة تماما، فيقرر أن لا يُعيدها الي الحياة، وإنما يقوم باستبدال مخها بمخ الجنين الذي في بطنها، ظنا منه أنه بذلك يعطيه فرصة للحياة والاختيار في المستقبل.

يخلق دكتور غودوين، والذي يشار اليه دائما في الرواية والفيلم بـ”دكتور غود” God، أي الطبيب الإله، مخلوقة جميلة للغاية، ولا يتنصّل منها، بل يعتبرها ابنته، ويعطيها اسمه، ويقوم برعايتها وحمايتها في بيته من العالم الخارجي، الذي يمكن أن يؤذيها، أي أن ما فعله هو بالضبط عكس ما فعل الدكتور فيكتور فرانكنشتاين. فقد منح الحياة المثالية، والمحبة، والأهم الاعتراف.
بيلا باكستر، المخلوق المثالي، لم تكن إلا طفلا في جسد امرأة ناضجة، تحاول استكشاف العالم والمدينة ،والخروج من كنف ابيها دكتور غود. وفي أحد الأيام تُقرر التمرّد على حياتها، وتأجيل خطبتها من تلميذ أبيها النجيب، لتسافر إلى العاصمة البرتغالية لشبونة، في رحلة مع المغامر دانكن ويدربيرن. ومرة أخرى نجد الدكتور غود يلتزم بمبدأ حرية الاختيار، ويسمح لبيلا بالخروج في رحلة استكشاف للذات والعالم.
تتنقل الأحداث بين عدد كبير من البلاد الأوروبية والشمال إفريقية، وتخوض الطفلة في جسد امرأة رحلة، تتشكّل فيها ذاتها، عن طريق احتكاكها مع المنظومة الذكورية التقليدية التي تحاول أسرها؛ وأحيانا مع عوالم الفقر والقسوة في العالم، خارج الفقاعة التي صنعها والدها. لتسقط في العدمية، عندما ترى أن هذا العالم فاسد وقاسٍ، لا يمكن تغييره، قبل أن تستعيد الأمل.
يضعنا ألسدير جراي في عالم بأجواء فيكتورية، مماثلة لرواية فرانكنشتاين، لكنها تحتوي على الحد الأدنى من الأسس الأخلاقية في عصره، وعصرنا، لم يعد العلم أبا قاسيا، يُجري تجاربه اللا إنسانية علينا، مثل دكتور فرانكنشتاين. بل أبا عطوفا رحيما، يعطينا الاعتراف والتمكين والحرية، ويؤمن أن البشر يمكنهم أن يتخلّصوا من عبء تنشئتهم الاجتماعية والتعليمية، ويختاروا لأنفسهم مسارا أفضل في الحياة، كما اختار دكتور غود نفسه أن يكون بتلك الرحمة والتعاطف تجاه ابنته/مخلوقه بيلا، على عكس والده القاسي، الذي كان يجري تجاربه العلمية على جسده، بدون أدنى شفقة، أو اعتبار لإنسانيته.
تقدّم الرواية نقدا لكل الصور الأحادية: العلم التجريبي، المُجرّد من العواطف والشفقة والأخلاق، مُمثلا في والد دكتور غود؛ الدين، بوصفه مؤسسة ذكورية من ناحية، ولا يقوم على أسس علمية أو واقعية من ناحية أخرى؛ النظرة التشاؤمية للعالم؛ البنى الطبقية، والمجتمعات البرجوازية المُغلقة على نفسها؛ النظرة المُستهجنة للحرية الجنسية والتجربة. ولكن ما يجعلها رواية “بعد حداثية”، أنها تلعب على حدود الثنائيات، دون أن تستقر في أي منها، أو تندمج في أي خطاب من الخطابات، سواء كان محافظا أو تقدميا، علميا أو رومانسيا. وتفكك كل ما يبدو موجودا بشكل بديهي في عالمنا، فهي تقدّم عصرا علمانيا يحوي إيمانا بدون ملّة؛ أخلاقا بدون إله؛ “نسوية اشتراكية” لا تغيّر إلا حياة أصحابها الفردية؛ و”علما مرحا” Gay science، كما تمنّى الفيلسوف الألماني فريدريش نيتشه، ولكن دون كثير من تمرّده.
إنها الحداثة المُهذّبة، بذواتها التي تتراوح بين الأخلاقية المفرطة والعدمية المتشكّية. ربما كان مخلوق دكتور غود محاولة لتجاوز مآسي مسخ دكتور فرانكنشتاين، ولكن هل هو كذلك فعلا؟
ينقسم فيلم المخرج لانثيموس الي محطتين: الأولى بالأبيض والأسود، ونرى فيها بيلا باكستر، المخلوق الجميل، وهو يمارس طفولته وسذاجته الأولى، داخل بيت الدكتور غود. فهو لا يعرف ما يفضّل من طعام، أو ما يُشعره بالسعادة، ولا يمتلك نظرة ذاتية لنفسه، وحتى لا يعرف كيف جاء الي هذا المكان؛ والمحطة الثانية بالألوان، عندما تذهب بيلا مع دانكن المخادع في رحلة لأوروبا، من أجل التجربة واستكشاف ذاتها ومعرفة العالم.
تُذكّر ذاتية بيلا بمفهوم الذات عند الفيلسوف الدنماركي سورين كيركغارد، الذي يرى أن الذات تولد من خلال مركب متناقض بين عدة عناصر، مثل الواقع والمثال، الضرورة والإمكان، الجسد والنفس. هذه التناقضات هي ما تشكّل الذات الحرة، على هيئة صراع وتوتر دائم، وخصوصا عند احتكاكها بالمؤسسات الاجتماعية في حياتها العادية. فبيلا عبارة عن تركيب جسد امرأة ناضجة ووعي طفل، وهي لا هذا ولا ذاك، انها مركب متوتر بين واقع قاسٍ متسلّط، يحاول التحكّم فيها، مكوّن من سلطات ورجال ونساء أشرار؛ ومثال تجده في الفلسفة، وفي قراءة أدب الكاتب الأميركي رالف إيمرسون، والمشاركة في تجمّعات الاشتراكيين، والأمل في الشرط الإنساني، والقدرة على تغيير الواقع المأساوي، والمناداة بالحرية الجنسية، وهدم النظرة الأحادية لها.
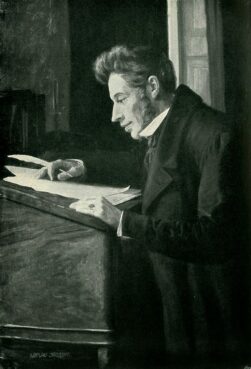
هكذا تمرّ بيلا بمراحل الحياة الذاتية، كما وصفها كيركغارد تقريبا، وهي المرحلة الجمالية، والأخلاقية، والدينية، على أن تكوّن الأولى والثانية مركّبا جدليا، يلد المرحلة الدينية. ففي المرحلة الجمالية The Aesthetic Phase يطارد الانسان سعادته الحسيّة، ويعيش الرغبة لأجل ذاتها. هكذا أغوى المغامر دانكن بطلتنا بيلا بمجرّد لمسها، ووعدها بتجربة جنسية لامثيل لها، ونشوة لم تنعم بمثلها من قبل. وبيلا توافق، وهي تلتهم المأكولات بشراهة، وترقص على أصوات الموسيقى بشكل طفولي، ومحرج لدانكن نفسه أحيانا.
وأثناء رحلتها على متن السفينة مع دانكن، تقابل بيلا امرأتين مثقفتين، تقرأ إحداهما لها أدب إيمرسون، وتنصحها بالقراءة عموما، واستكشاف أدب غوته أيضا. هنا تبدأ بيلا المرحلة، التي يسميها كيركجارد بـ”الجمالية التأمليّة”، والتي تبدأ فيها الذات باكتساب لغة، من خلال التأمل وتحطيم الحياة الحسيّة المباشرة، وبداية التمييز بين الذات والعالم الموضوعي الخارجي. انها اللحظة التي تتفطّن فيها بيلا إلى أن دانكن ساذج وأناني، لا يمكنه أن يضيف إلى ذاتها أي شيء.
من هنا تبدأ المرحلة الأخلاقية The Ethical Phase وفيها تأخذ بيلا قرارها الحقيقي الأول. بداية تقرّر التبرّع بالأموال لأجل الفقراء والمشردين، في جزيرة تمرّ السفينة بجانبها؛ ثم مفارقة دانكن، والعمل في بيت للدعارة، من أجل معرفة ذاتها. يقول كيركجارد: “الفرد الأخلاقي يعرف نفسه، غير أن هذه المعرفة ليست مجرد تأمّل، إنها تفكير في ذاته، وهو فعل، ومن ثمَّ فضّلت استخدام تعبير اختيار الفرد لذاته، بدلا من معرفة الفرد لنفسه”.
تختار بيلا ذاتها هذه المرحلة، وتبدأ بالتعرّف على العالم الاجتماعي، من خلال بنى السيطرة والامتلاك في عالم الدعارة، وتقرر مقاومة ذلك العالم، مع رفيقتها الاشتراكية.
المرحلة الثالثة هي المرحلة الدينية The Religious Phase والتي تعود فيها بيلا إلى أبيها دكتور غود، لتعرف حقيقتها، وكيف جاءت الي هذا العالم، وتقرر في النهاية أن تصبح طبيبة مثل أبيها، وأن تخلفه بعد وفاته، أي أن تصبح هي الإله. بعد أن تدرك ذاتها، وهويتها التي اصطنعتها، وتؤمن بالحقيقة والشفقة والتعاطف، القادرين على تغيير العالم.
إلا أن وصول بيلا لهذه المرحلة الدينية لا يشبه الفكرة المسيحية، التي آمن بها كيركغارد، والتي يتخيّل فيها بطلا دينيا، يتخلى عن ذاته وأغلى ما يملك، ويستسلم لخالقه اللامتناهي، إنما تقدّم بيلا صورة علمانية بديلة، لأقصى ما يمكن أن تصل له الذاتية الحديثة، وهي الايمان بالحقيقة، وقدرتها على هزيمة الأساطير الدينية، والمؤسسات الاجتماعية البالية، وتأسيس شرط انساني أفضل. الغريب فقط، في كل تلك “التقدمية”، أنها ليست سوى عودة للأب/الإله، الذي منحنا الحرية والتمكين بقرار منه أصلا.
في كتابه “منابع الذات: تكوّن الهويات الحديثة”، يخبرنا الفيلسوف الكندي تشارلز تايلور بأن عديدا من مفاهيمنا عن الذات، الهوية، الأنا، الأيغو، الكوجيتو، الفردانية وحتى “الموضوع”، مفاهيم مخترعة حديثا، نستعملها يوميا، دون أن ندري تحديدا كيف نشأت، ولماذا.
يؤكد تايلور بأننا في حاجة للتفكير في هذه المفاهيم قبل استخدامها، والعتبة الأولى في سلم هذه المهمة هي إدراك أن ما نظنه وجودا “باطنيا”، نمتلكه جميعا، يتشابك مع تصورات أخلاقية مُفترضة بشكل مُسبق. ولا يمكننا أن “نكتشف ذاتنا” فعلا إلا باستخراج تلك المعطيات الأخلاقية الخارجية من باطننا، ومناقشتها بشكل ملفوظ أو مكتوب: فـ”البشر ليسوا أشياء حيادية، بل موجودون في فضاء من المسائل، وخلال تآلف معيّن”. ومناقشة مضمون الأخلاقيات المفروضة على “باطننا”، يساعدنا أكثر على فهم أنفسنا وعالمنا، وقبول تعددية الأخلاق والتصورات بتعدد أصحابها، دون واحدية أو نسبوية.

ويعتبر تايلور أيضا بأن ذاتنا الحديثة لم تتغيّر منذ العصر الفيكتوري، وهي تعمل بطريقتين: الأولى بالتأمل في “الداخل”؛ والثانية من خلال تأكيد أخلاق الحياة العادية في المجتمع. إلا أن مناقشة كل من الذات والأخلاق العادية، ضروري لتوسيع إطارها وتغييرها.
تقدم لنا بيلا خلال فيلم Poor Things نموذجا لتلك الممارسة الفلسفية، فهي، في وقت ما، ظنّت أن بإمكانها تغيير العالم، لتنتهي إلى تأكيد أخلاق الحياة العادية، بعد “توسيعها”، عبر التأمّل والتجربة الذاتية الطويلة؛ وتلتزم بالبحث عن الحقيقة العلمية والانتاج البشري وبناء الأسرة وحتى الحب، ولكن بعد أن تنتقد كل ما هو ذكوري واستغلالي ومخادع. لا يمنعها هذا كله في النهاية من أن تتزوج تلميذ والدها، وتتولى إدارة معمله.
ربما تكون هذه نهاية سعيدة للبعض، ومخيّبة لآمال البعض الآخر. إذ يبدو أن نسخة مسخ فرانكنشتاين المُعدّلة قد صارت الإله، الذي حلم به الصانع، ولكنه إله يحتاج دائما للبيئة الأبوية الصناعية التي أنتجته. ماذا عن مّن لا يملكون ترف العيش في تلك البيئة؟ بل ماذا إذا تعرّضت لأزمة كبرى؟ لا يعالج الفيلم هذه الاحتمالات بصورة واضحة.
هل أعجبك المحتوى وتريد المزيد منه يصل إلى صندوق بريدك الإلكتروني بشكلٍ دوري؟
انضم إلى قائمة من يقدّرون محتوى الحل نت واشترك بنشرتنا البريدية.














مقال ممتع وكاتب مثقف صاحب رؤية
مبهور وممتن