الرواقية الجديدة: ماذا نفعل عندما يكسر السيد أرجلنا؟


في قصةٍ متوارثة، يُحكى عن وزيرٍ حكيم، يستشيره ملكه في شؤونه، فيكرر الوزير عبارة: “لعله خير”، كلما نزل بالملك ما يعكّر صفوه. وفي إحدى المرات قُطع إصبع الملك، فقال الوزير: “لعلهُ خير”، فاشتاط الملك غضبا، وقال له: “ما الخير في ذلك؟”، وأمر بحبسه مباشرةً، فقال الوزير: “لعلهُ خير”.
وفي يوم من الأيام، خرج الملك للصيد، وابتعد عن الحراس ليتعقّب فريسته، ولكنه وقع تحت قبضة قوم يعبدون الأصنام، فقرروا تقديمه قربانا لصنمهم، ولكن زعيمهم انتبه أن أصبع الملك مقطوعة، ولا يليق أضحية للصنم، فأفرج عنه. حينها انطلق الملك فرحا بأنه نجا من موت محقق، مدركا الخير فيما أصابه. وذهب مسرعا إلى قصره، واعتذر من الوزير، ثم سأله: “ما الخير الذي وجدته في سجنك؟”، فأجابه: “لو لم تسجني لصاحبتك في الصيد، وكان سيقع الاختيار عليّ كي أُقدم قربانا بدلا منك، فأصبعي سليمة”.
هذه الحكمة في التعامل مع المصاعب، والحياة بشكل عام، تبدو نوعا ما قريبة مما هو دراج حاليا في الثقافة الجماهيرية عن الفلسفة الرواقية. يمثّل الوزير في القصة، رجلا يمكن القول عنه، بلغة الرواقية، إنه وصل إلى مرحلةٍ الحكيم The Sage؛ ومن خلال هذه القصة، والتي لا علاقة لها بالأدبيات الرواقية، يمكن أن يفهم كثيرون كيف تُبنى حياة الرواقي الكاملة.
ومن فلاسفة مثل زينون وماركوس أوريليوس وسينيكا قديما، وحتى الفيلسوف الأميركي رايان هوليداي في عصرنا الحالي، تشهد “الرواقية” انتعاشة غير مسبوقة، إذ تمتلئ منصات التواصل الاجتماعي بمنشورات وتغريدات وفيديوهات، وصفحات بملايين المتابعين والمشاهدات، تنقل نصائح وحكم الإغريق والرومان القدامى، عن الجَلَد وتحمّل المصاعب، مقدمةً إياها على أنها حكمةٍ كونية، تشاركها الأباطرة والعبيد، وكذلك رواد الأعمال المعاصرون، لدرجة باتت “الرواقية” نوع من الفلسفة الجماهيرية Pop Philosophy.
فكيف لفلسفة، كُتبت منذ ألفي عام، بلغةٍ مختلفة، أن تؤثّر على المتلقين المعاصرين؟ وما سبب انتشارها في عصرنا فعلا؟ وكيف لها أن تفيد، إن أفادت، في مواجهة ما نمرّ به اليوم من أزمات وكوارث؟ وما الرواقية فعلا؟
تُروَّج الرواقية في هذه الأيام على الإنترنت، عبر اقتباسات من كتب المساعدة الذاتية، المليئة بنصائح شافية ومعافية من الخلل، الذي أصابنا نحن البشر، بسبب نكراننا لعجزنا، وعدم إدراكنا لمحدودية أفعالنا. ولكن تلك الفلسفة أقدم وأعرق بكثير، وتعود إلى أكثر من ألفي عام، فكتاباتها الأولى تعود إلى الإغريق، وما نجا منها تناقله الرومان.
من أبرز روادها، زينون، سينيكا، ابيكتيتوس، والإمبراطور الروماني ماركوس أوريليوس، وتتلخص أفكارها، بشكلٍ مبسّط ومخل نوعا ما، في أنها فلسفة تزرع في الإنسان حكمة التخلي عن الإيغو، وإدراك أن الحياة أكبر وأقسى منه بطبيعة الحال، ولا يمكننا التحكّم في معظم ما يحدث لنا، لذلك لا جدوى من الغضب تجاهه.
كان للفلسفة آنذاك دورُ مغاير عما نعرفه في عصرنا، فمثلاً لا يُعدّ كتاب “التأملات” للإمبراطور ماركوس أوريليوس كتابا فلسفيا بالمعنى المنضبط، بمعنى أنه لا يحاول بناء مفهوم، عبر طرح الأسئلة، وبناء أسئلة أخرى، على أساس الاستنتاجات المستخلصة منها. فالفلسفة، طبقا له، لم تكن موضوعا للمحاججة، بل أداةً عملية لبناء خطة حياتية، أو تصميم للعيش، أي مجموعة من القواعد، يُلزم المرء بها نفسه، وهذه كانت حاجةً لم تلبها الأديان القديمة، القائمة على الطقوس لا على العقيدة، والتي قدّمت قليلا تجاه ما هو مطلوب بالفعل.

تقوم الرواقية على ثنائية، تتعلّق بقدرتنا على التحكّم (The Dichotomy of Control): تحكّم بما يمكنك التحكم؛ ودعك مما لا يقع في نطاق قدرتك. مفتاح فهم الرواقي هو الاقتناع بأن الشيء الوحيد الممكن التحكّم به هو قدرتنا على الحكم على ما يحدث لنا. والحكم الصحيح، الذي له حمولة عاطفية، أن تدرّب نفسك على فحص كل ما تمرّ به، دون التسرّع إلى حكم عاطفي. لأن القدرة على التحكّم هنا متعلقة بالمشاعر وليس بالأحداث. ولذلك ينزع الرواقي إلى تطويع أحكامه مع واقعه، بدون حمولةٍ عاطفية زائدة، فلا شيء إيجابي أو سلبي. لا فرحة زائدة تجاه حدثٍ جيد، أو حزن مبالغ فيه تجاه حدثٍ سيء.
تذكر الأدبيات الرواقية عن ابكتيتوس، صاحب كتاب “المختصر”، وهو من الأدبيات الأساسية لمن يرغب في التعرّف على الرواقية، أنه كان عبدا، كسر مالكه قدميه عمدا، ولم يبدر منه أي انفعال ينمّ عن السخط. وكانت، وما زالت، إحدى أشهر مقولاته: “المعاناة تنبع من محاولة التحكّم بما لا يمكن التحكّم فيه، أو من تجاهلنا لما في محيط قدراتنا“.
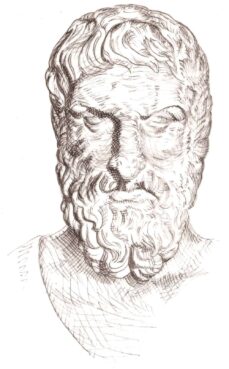
المشاعر لها محتوىَ معرفي، لا تنفصل عن حكمنا العقلي. وينبغي عليك، باعتبارك رواقيا، أن توائم ما تشعر به مع ما يحيط بك من أحداث، فالانفصال بين ما تشعر به وما تحكم عليه، وبين الواقع، هو السبب الأساسي للقلق والتوتر الذي تشعر به. وفي سعي الرواقي نحو حياةٍ مسالمة، يبحث عن “الفضيلة”، وهي الخير الوحيد. ومعنى الفضيلة الحكم الدقيق على الواقع، فلا فضيلة سوى في أن تعيش في تناغم مع الطبيعة الخارجية، والطبيعة البشرية.
في قصة الحكيم المذكورة أعلاه، نجد أن الوزير لم يضاعف مشاكله بأحكام خاطئة، ولم يجزع لخبرٍ سيء، فكل ما يهم الرواقي أن يكون حكمه صحيحا، وأن يقبل فقط بما يمكنه التحكّم به، ولا يتعثّر في محاولات التحكّم بما هو خارجٌ عن قدرته.
الرواقية، في جانب منها، فلسفة عزائية، تؤطّر الصعب والمؤلم بوصفه حدثا طبيعيا. ولكن هل تقدّم لنا حلولا؟ هل تمنع أن يكسر الأسياد أقدامنا؟
ربما تعتبر الرواقية فلسفة أخلاقية مناسبة بالنسبة لمن تمتلئ حياته بعوائق شتى، فإذا كنت تمرّ بوقت عصيب، أو في أزمة مرحلةٍ عمرية ما، أو حتى في السجن. إذا كنت مقيدا ووحيدا ومُعذّبا نفسيا، فإن الرواقية تجلب لك صلابة نفسية. لكن، إذا كنت تعيش تفاصيل “الحياة العادية” في عالمنا المعاصر، بأنظمته القهرية، المغايرة لمنشأ تلك الفلسفة، فإن الرواقية، باعتبارها منهجا عمليا للحياة، لن تساعدك في التعامل مع العصر.
مثل أي حركة فكرية أو دينية، تعتمد شعبية الرواقية على براعة انتقاء واختيار الأجزاء المناسبة منها. يمكننا أن نومئ برأسنا بحكمة إلى بعض الأقوال المأثورة في صفحة من كتابٍ قديم، ولكن نتجاهل بلباقة الأقوال الغريبة أو غير المفهومة التي تليها؛ ويمكننا إخراج القدماء من سياق عصرهم، و”تحديث” مشاكل الرواقية، ولكن عند أي نقطة قد تصبح الرواقية نوعا مما يسمى “تأثير فورير”، وهو “لدينا شيء لكل واحد من الجمهور“، أي أن نطرح كلاما موحيا، ككلام المنجمين، ولكنه غامض، وقابل لأي تأويل، من ناحية المعنى.
على سبيل المثال، غالبا ما يكرر الرواقيون فكرة أننا يجب أن نقبل الأشياء التي هي خارجة عن سيطرتنا. ومع ذلك، تقليديا، فعلوا ذلك على أساس التزام شبه ديني بعالم محدد سلفا. يعتقد الرواقيون أن هناك خطة للطبيعة، ولذا يجب علينا أن نوافق عليها، بينما من المتماسك فلسفيا القول إن تبنى الاعتقاد القائل: “اقبل ما لا يمكنك تغييره”، يعني رفض قدرية الإيمان الرواقي بـ”الطبيعة”، لأننا، إذا آمنا بها، يجب أن لا نقبل ما نعتبره “غير طبيعي”، حتى لو لم نستطع تغييره.
تأثراً بالأدبيات الرواقية، ظهر نوع من علم النفس يعتمد على الحديث Talk Therapy، وهو من فروع العلاج المعرفي السلوكي، البعيد عن التحليل النفسي. في جوهره يركز العلاج المعرفي السلوكي CBT على الوصول إلى عبارةٍ ملخّصة لشعور معين، ومن هذا العبارة تُستخدم أدوات نفسية للوصول إلى حكمٍ أكثر موائمة للواقع. فمثلا بعد فقدان شخصٍ عزيز، والشعور بـ”أن الحياة تستقصدنا بالمصائب”، أو “أنا لن أكون سعيدا أبدا”، يجب أن نقول لأنفسا: “هكذا هي الحياة، والفقدان جزء متأصّل فيها”.
ولكن هل يحق لنا نقد للعلاج المعرفي السلوكي والرواقية في آن واحد؟ وهل يمكننا عدم تشجيع الأشخاص على قبول أشياء لا ينبغي عليهم قبولها؟
كانت العقلانية والنقد ممارسات رواقية مهمة (إن لم تكن الأكثر أهمية). ومن المفارقات أنه سيكون من غير الرواقي تماما أن نبتلع “الرواقية” المعاصرة، المنتشرة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بدون انتقاد، أو حتى لحظة من التفكير.
في الوضع الحالي، تستورد الرواقية، بلغة روّاد الأعمال، وتُجتزأ من سياقها الفلسفي، والظروف التاريخية لمؤسسيها. لدرجة أنها على ما يبدو لم تعد تستخدم إلا أداةً للإخضاع. فما المانع من إخبار العامل مثلا أن ما يمرّ به من ضغوطات لا ينبغي أن يؤثّر به؟ أو أنه نتيجة تقصير منه؟ أو أنه لم يتحكّم بشكلٍ كافٍ بعواطفه أو طاقاته؟ ثم إذا كانت العوامل الخارجية تفرض على المرء مشاعر معينة، والرواقية تطلب التحكّم التام في المشاعر، فكيف يتأتّى لنا تغيير العالم من حولنا؟
يوحي روّاد الأعمال، بأسلوب “رواقي”، أن روتينهم هو ما أتاح لهم فرص الثراء والترقي الاجتماعي؛ كما أن يقظتهم، وحسن إدارتهم، هي سبب نجاحهم. فهم عرفوا كيف يتعاملون مع الحياة ومصاعبها. وهكذا يستخدم الرواقيون الجدد، ممن لا يختلفون عن مدربي التنمية البشرية إلا في اللغة، حِكَما وأمثلة جاهزة، من المفترض أنها “فلسفة رواقية”، تجعل المرء صلبا في حياة مُرة.
وإذا كانت “الطبيعة”، “الإله”، “الكلمة”، “العناصر الأربعة”، هي الحقائق التي كان يجب التأقلم معها، في الشرط الفكري الذي ظهرت فيه الرواقية قبل ألفي عام، ففي الواقع الحديث، تتجاهل نصائح الرواقيين الجدد أن “الطبيعي” في هذه الفترة هو أن هناك نظاما يٌحكم سيطرته على الأفراد، ويضعهم في عجلةٍ لا تنتهي من التوتر، والسعي اللانهائي بدون مكاسب.
كانت كتب الفلسفة القديمة تحتفي بالصبر، والتماشي مع الطبيعة، لحكمةٍ إلهية، لكننا اليوم لسنا إلا أمام “حكمة” رأسمالية، أو “واقعية رأسمالية”، على حد تعبير الفيلسوف البريطاني مارك فيشر. الذي عرّف تلك “الواقعية” بأنها “التصور المنتشر بأن الرأسمالية أصبحت واقعا لا بديل له. وقد تحقق بذلك الهدف الأسمى للأيديولوجيا: أن تكون غير مرئية”.
يقدّم لنا فيشر تصورا للمشكلة التي يقع فيها الأفراد في عصرنا، ففي مقال له بعنوان “خصخصة الإجهاد” يذكر أن تلك الخصخصة “هي نظام التقاط مثالي، أنيق في كفاءته الوحشية. رأس المال يجعل العمّال مريضين، ثم تبيع لهم شركات الأدوية متعددة الجنسيات العقاقير، لجعل حياتهم أفضل. يتم تجنب السببية الاجتماعية والسياسية للضائقة التي نمر بها، في الوقت الذي يتم فيه إضفاء الطابع الفردي والداخلي على السخط الاجتماعي العام. كان النظام الدوائي للطب النفسي محوريا في خصخصة الإجهاد ، ولكن من المهم ألا نتجاهل الدور، الذي ربما يكون أكثر غدرا، الذي لعبته أيضا ممارسات العلاج النفسي، الأكثر شمولية في عدم تسييس الضائقة“.

ولأن الرواقية الحديثة، وكتب التنمية الذاتية، تخاطب كل فردٍ على حدة، فلا شيء فيها يدعو للاجتماع أو التآزر، بل فقط إلى الصبر، فبهذه الطريقة يجابه كل فرد حياته وحده، صابرا عليها وحده، محاولا التحكّم في عواطفه وحده. وإذا كان نصائح الرواقية مناسبة ومواسية في حينها، فهي الآن تساعد في إرساء فردية، تقوم عليها “الواقعية الرأسمالية”. يذكر فيشر أن هناك عملية “تذرية” atomization (التحويل إلى ذرات متناثرة) تحدث للفرد ضمن هذه الواقعية. ومناهج العلاج النفسي تساعد على ذلك.
يقول فيشر: “يجادل المعالج الراديكالي ديفيد سمال بأن وجهة نظر مارغريت تاتشر بأنه لا يوجد شيء اسمه المجتمع، فقط الأفراد وعائلاتهم، تجد صدى غير معترف به في جميع مناهج العلاج تقريبا، وبذلك تجمع العلاجات، مثل العلاج السلوكي المعرفي، بين التركيز على الطفولة (بوصفه نوعا من التحليل النفسي الخفيف)، وبين خطاب المساعدة الذاتية، القائل بإن الأفراد يمكن أن يصبحوا أسياد مصيرهم. ويمنح سمال اسما موحيا للغاية، وهو “التطوع السحري”، للرأي القائل بإنه بمساعدة خبير معالج أو مستشارك النفسي، يمكنك تغيير العالم، الذي أنت مسؤول عنه في التحليل الأخير، بحيث لا يعود يسبب لك الضيق“.
كان نشر “التطوع السحري” حاسما لنجاح الأيديولوجيا النيوليبرالية، برأي فيشر، إلى درجة يمكن معها القول إنه الأيديولوجية العفوية لعصرنا. وهكذا، على سبيل المثال، أصبحت الأفكار عن العلاج بالمساعدة الذاتية مؤثّرة جدا في البرامج التلفزيونية الشعبية، التي تروّج صراحة لنوع من ريادة الأعمال النفسية. تؤكد لنا تلك البرامج أن القيود المفروضة على إمكاناتنا الإنتاجية تكمن في داخلنا. إذا لم ننجح، فذلك ببساطة لأننا لم نقم بالعمل لإعادة بناء أنفسنا. وبذلك تمنع الأنظمة الحالية تكوّن أي وعي جمعي، عن طريق وضعنا في حالة دائمة من التوتر والفزع والشعور بالذنب والتقصير.
لقد كانت “خصخصة الإجهاد”، برأي فيشر، جزءا من مشروع يهدف إلى تدمير شبه كامل لمفهوم الجمهور، إذ يجد العمال أنفسهم يعملون بجهد أكبر، في ظروف متدهورة، ومقابل أسوأ الأجور، من أجل تمويل إنقاذ الدولة لنخبة رجال الأعمال، في حين أن عملاء تلك النخبة يخططون لمزيد من تدمير الخدمات العامة، التي يعتمد عليها العمال.
نهاية، ترسّخ الرواقية المعاصرة لأفكار سلبية، وتجعلنا نعجز عن إدراك الفرق بين ما يمكننا التحكّم فيه، وبين ما يمكننا التأثير عليه. فهل ينبغي علينا مثلا أن نتخلى عن التفكير في مشكلة المناخ وتوابعها لأننا لا نستطيع التحكّم في الطبيعة؟ هل ينبغي علينا أن نتنازل عن المطالبة بحقوق العمال لأن النظام الرأسمالي الحالي يمضي نحو تكريس مصالح صفوةٍ، تغتني على حساب الكل؟ هل ينبغي علينا أن نصمت ونسلّم بهيمنة أسياد مستبدين، دينيين أو عسكريين، لأن النظام الاجتماعي قائم على هذا؟
لا شيء من هذا يعني أن الرواقية فكرة سيئة بالمجمل. في الواقع، هناك كثير من الحكمة فيما ورثناه من فلاسفتها. لكن هذا لا يعني أننا يجب أن نوقف قدراتنا النقدية. فانتقاد جوانب الشيء لا يعني التنكّر للكل. وربما كان أساس التفكير النقدي اليوم إدراك أن الحل سياسي وليس فرديا، وأنه هناك مساحة شاسعة بين العجز عن التحكّم في ما حولنا، والعجز عن التأثير. ليس بإمكاننا وحدنا تغيير العالم، ولكن الأصوات المجمّعة يمكن أن تُسمع بشكل أفضل.
هل أعجبك المحتوى وتريد المزيد منه يصل إلى صندوق بريدك الإلكتروني بشكلٍ دوري؟
انضم إلى قائمة من يقدّرون محتوى الحل نت واشترك بنشرتنا البريدية.













